- الصفحة الرئيسية
- مقالات منوعة
- يوسف مقداد
يوسف مقداد
يوسف مقداد
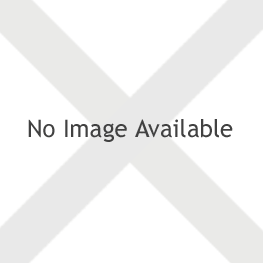
29-07-2020 04:44 PM
سرايا - السلطة والشعب في مفهوم الدولة
قدم الفقهاء والفلاسفة العديد من التعريفات للدولة، فموسوعة لاروس الفرنسية اعتبرتها مجموعة من الأفراد الذين يعيشون على أرض محددة، ويخضعون لسلطة معينة. في حين عرفها الفقيه الألماني ماكس فيبر على أنها منظمة سياسية إلزامية مع حكومة مركزية تحافظ على الاستخدام الشرعي للقوة في نطاق معين من الأراضي. أما في اتفاقية مونيفيديو- Montevideo – لسنة 1933 فتم تعريف الدولة على أنها مساحة من الأرض تمتلك سكان دائمون، وإقليم محدد، وحكومة قادرة على المحافظة والسيطرة الفعالة على أراضيها، وإقامة العلاقات الدولية مع الدول الأخرى. كما عرفه الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة، بأن الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة.
1- أركان الدولة
من خلال ما تم تقديمه من تعريفات لمفهوم الدولة، يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية.
- الشعب: إن وجود الشعب ركن أساسي في الدولة، إذ لا يمكن أن نتصور دولة بدون شعب. ويتكون الشعب من مجموعة من الأفراد/الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، ولا يشترط تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب لتكوين الدولة، إلا أن كثرة عدد السكان يعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها.
- الاقليم: لوجود الدولة، لا بد أن يستقر الشعب على أرض معينة، والاقليم رقعة جغرافية يستقر عليها الأفراد، ويمارسون فوقها حياتهم اليومية وأنشتطتهم بشكل دائم. وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم البري الذي يشتمل اليابسة أي البر، والمسطحات المائية التابعة لليابسة ويسمى بالاقليم المائي. بالإضافة إلى الفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة المسمى بالاقليم الجوي. وتمارس الدولة حقها على إقليمها من منطلق السيادة.
- السلطة السياسية: لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة. بل لابد من وجود سلطة أو حكومة تعمل على تنظيم أمور أفراد الشعب، وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها.
وفي هذا الإطار، يطرح البعض تساؤلات:
هل يجب أن يخضع الشعب للسلطة ؟
وما هي علاقة الشعب بالسلطة ؟ بل أين موقع الشعب في علاقته مع السلطة ؟
2- علاقة الشعب بالسلطة
شكل التساؤل عن علاقة الشعب بالسلطة السياسية في الدولة محور جدل منذ نشأة مفهوم الدولة بحد ذاتها، بل منذ نشأة المجتمعات الانسانية. وقدم الفقه والفلاسفة آراء متباينة في هذا الخصوص.
وقد أجاب توماس هوبز عن التساؤل (لماذا يجب أن نخضع للسلطة؟)، بأن وضع نفسه افتراضيا في مرحلة ما قبل المجتمع (state of nature)، بأن الانسان في هذه المرحلة يتركز اهتمامه في المصلحة الذاتية، وبسبب قلة المصادر وغياب السلطة فإن البيئة الحياتية سوف تكون قاسية جدًا وصعبة التحمل بشكل يخشى كل فرد على حياته من الآخر مع عدم ضمان تلبية حاجاته ورغباته لمدة زمنية طويلة. ووصف هوبز هذه المرحلة بالهمجية، وأن الخروج من هذه المرحلة يجب أن يكون عبر الاتفاق على الهيش تحت قوانين مشتركة، والاتفاق على إيجاد آلية لفرض هذه القوانين عن طريق سلطة حاكمة، وأن تكون السلطة مطلقة وإن ظهرت لديها انحرافات، معللًا رأيه بأن السلطة هي الشيء الوحيد الذي يقف بيننا وبين الهمجية.
وقد استخدم الفقيه جون لوك نفس المنهجية مع هوبز، واختلف معه في كون الحالة الأصلية state of nature مع انعدام القوانين فيها ممكنة التحمل، مبررًا ذلك بأنها رغم كل شيء فإنها تحتوي على أسس أخلاقية. كما خالفه في السلطة المطلقة، ورأى أن الفرد له الحق في مقاومة السلطة المستبدة، انطلًاقا من حق الدفاع عن النفس.
أما جان جاك روسو، فقد خالف هوبز و لوك حول الحالة الأصلية state of nature بأن وصفوها بالهمجية المليئة بالمشاكل والظروف السيئة والفقر، وتوقع روسو أن الناس كانوا يعيشون في الحالة الأصلية بسلام وباكتفاء ذاتي بسبب الأخلاق السائدة. ويرى روسو أن تجمع الناس كان نتيجة لعوامل اقتصادية...
وعموما، فإن الحكومة / السلطة في أي دولة، تستمد شرعيتها من رضا الشعب، وقبول الشعب لها، فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون حكومة فعلية وليست شرعية، وذلك مهما فرضت نفوذها على الشعب، ومهما لجأت للقانون، وهو أمر ضروري (اللجوء للقانون) لتنظيم الأفراد، وخاصة لعدم تغليب مصالحهم الخاصة على حساب الصالح العام.






